البطل
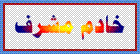


شفيعـي : البابا كيرلس
المزاج : ماشى الحال
الهواية : 

 [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td] [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td][أولاد أم النور][/td][/tr][/table]
 |  موضوع: التوبة شئ ايجابى ام سلبى ... تاملات موضوع: التوبة شئ ايجابى ام سلبى ... تاملات  السبت 12 ديسمبر 2009, 4:37 pm السبت 12 ديسمبر 2009, 4:37 pm | |
|
<H2>التوبة شيء سلبي أم ايجابي؟
يجب أن تتوفر الشروط الآتية في كل مَنْ يريد أن يكون مؤمناً حقيقياً:
1 ـ الرغبة الخالصة في الحصول على الخلاص: وهذه الرغبة تتطلب في المرء أن يكون كارهاً للخطيئة وشاعراً بشناعتها وخطورتها، وموقناً باستحقاقه للحرمان من الله إلى الأبد بسببها، ولذلك ليس كل مَنْ يقول بفمه "ارحمني اللهم أنا الخاطئ" لأن العِبرة ليست بالكلام بل بالحالة التي تكون عليها النفس، فالمرأة الخاطئة لم تخلص إلا بعد أن أحسَّت بثقل خطاياها والتجأت إلى المسيح بكل قلبها (لو 7: 36 -50) وزكا كذلك (لو 7: 36 -10) واللص أيضاً (لو 7: 36 ) والذين آمنوا من اليهود في العصر الرسولي لم يتيسر لهم ذلك إلا بعد أن نُخسوا في قلوبهم، وشعروا شعوراً عميقاً بشناعة جريمتهم التي اقترفوها ضد المسيح، وآمنوا بعد ذلك بكل قلوبهم بشخصه الكريم (لو 7: 36 -41).
2 ـ التوبة عن الخطية: كما أن الشعور بشناعة الخطية يجب أن يكون مقروناً بالتوبة عنها، وإلا فلا فائدة من هذا الشعور على الإطلاق. ولا يُراد بالتوبة الندم على ارتكاب الخطيئة فحسب، بل والتحول عنها والرجوع إلى الله أيضاً. وإذا تعذر على إنسان أمر التوبة، فليعلم أن الله على استعداد لمساعدته لنيل التوبة. فمكتوب أنه تعالى "يعطي التوبة" (أع 5: 31 ، 11: 18) ولذلك صرخ أحدهم لله قائلاً "توبني فأتوب" (أع 5: 31 ) فأعطاه التوبة.
3 ـ الاتجاه إلى المسيح: على المرء أن لا يقف عند حد الندم على الخطيئة والتوبة عنها، بل أن يتجه بكل قلبه إلى المسيح، الذي أحبه ومات على الصليب كفارة عنه، فيستفيد منه، لأن خلاص المسيح ليس لفئة خاصة من الناس، بل لكل الناس دون استثناء.
4 ـ قبول المسيح في النفس: أما وقد توافر لدى طالب الخلاص أن الله يحبه بصفة شخصية، وأن المسيح مات نيابة عنه بالذات مكفراً عن كل خطاياه مثل غيره من الناس، فعليه أن يتجاوب مع المسيح ويقبله بالروح مخلصاً لنفسه وحياة لها، فيصبح الخلاص للتو ملكاً له. ومن ثم له أن يفرح ما شاء له الفرح وأن يطمئن ما شاء له الاطمئنان.
في إحدى الجلسات التي ضمَّت عدداً من المثقفين، فُتح باب المناقشة حول مشاكل العصر، وموقف الإنسان المؤمن من التسيُّب الموجود في المجتمع، والانحراف الذي يطل برأسه من خلف درج مكتب، أو طرف لسان رئيس عمل، أو من خيوط متشابكة معقدة في الأسرة أو في العمل أو في البيئة المحيطة. وطُرحت أسئلة كثيرة، مثل: ما موقف الإنسان المسالم من الاستفزاز المستمر، وخاصة أنَّ الصفح الدائم يجعل المستفز يتمادى ويتعامل بأسلوب غير أخلاقي؟ فما معنى الصفح في مجتمع لا أخلاقي؟! وتساؤل آخر... في مجتمع استهلاكي أصبح الذي معه القرش يساوي قرشاً.. هل يرهق الإنسان نفسه في العمل على حساب صحته وأسرته وعلاقته بالله؟!.. وهكذا توالت الأسئلة لتطرق باب كل موضوع في هذه الحياة.
وكان السؤال الرئيسي: كيف يحاسبنا الله؟!
والمأساة الحقيقية التي نعيشها هي طريقة فهمنا لله ولعلاقته بنا من خلال الوصايا. فنحن نتفق على أنَّ الإنسان يعيش حياة العصيان لله، فهو يعيش حياة الفجور وعدم المبالاة بقوانين وفرائض ووصايا الله، التي أعلنها لكي يحوّل الإنسان إلى طاعته، ولا شك في أننا نتفق على أنَّ الوصايا الإلهية هي أساس الطاعة. لكننا نتصور أنَّ الله يقدم لنا مجموعة من الوصايا الجامدة والعبادات كالصلاة والصوم والصدقة، يجلس ليراقبنا ولا هدف له إلا إحصاء أخطائنا ومحاسبتنا عليها. وهكذا تحكم الوصايا العلاقة بين الله والإنسان، ولا توجد علاقة مباشرة بينهما. فعلاقة الله بها أنَّه مصدرها، وعلى الإنسان أن يتقبَّلها، وهي تربط بين الإثنين، فإن أطاعها بحرفيتها دون تصرُّف منه فهو عبد لله، أما إذا حاول أن يفهم روحها وأن يعمل فكره فيها، كان مضاداً لله. لذلك يقف العبد أمام الوصايا صاغراً، محاولاً تفسيرها وتطبيقها على حالته الخاصة وفي معظم الأحيان يفشل.
لقد حاول اليهود تفسير الوصايا العشر في التلمود ﴿كتاب يجمع بين التعليم والتفسير للعهد القديم من الكتاب المقدس﴾، وذكروا كل حالة يمكن أن تقع تحت وصية منها بتفاصيل غاية في الدقة والغرابة. فهم يحددون المسافة - بالضبط - التي يسيرها المؤمن يوم السبت، ووزن الذهب الذي تحمله المرأة في حليّها يوم السبت. وفي حالة كذا .. يكون التصرُّف هكذا.. إلخ. وهكذا أصبحت الوصية الواحدة في تفسيرها ألف وصية ووصية.. ماذا تلبس المرأة؟ هل تغطي شعرها أم لا؟ ..إلخ. وتظهر المشكلة عندما يجد الإنسان نفسه في موقف غير منصوص عليه. هنا يقع في مأزق، وربما يقع ضحية لمفسرين مغرضين أو سطحيين، ولا يعرف إن كان قد تصرَّف خطأ أم صواباً، فيعيش يعاني من عقد الذنب التي تترسَّب في داخله.
والتعاليم التي نتلقاها اليوم تصور الله كائناً مجهولاً مختفياً خلف كلماته الموحى بها، وليس على الإنسان إلا أن يتعامل مع الكلمات. وهكذا نجعل الوصية هدفاً وليست وسيلة لهدف، فنتعب لكي نوفيها حقها. ونصبح عبيداً لها ولسنا عبيداً لله. وبهذا أصبح تفسير إنسان ما للوصية سبباً في تكفير أخيه الإنسان واستبعاده من قائمة المؤمنين بالله. لقد ألغى الإنسان بفكره وعبقريته مفهوم الوصايا الصحيح وإنسانيته في علاقته بالله وأصبح كائناً يتحرك في إطارها الحرفي. واليوم نرى الوصية بحسب ما فسَّرها الأقدمون - سيفاً مسلَّطاً على رقابنا. فالمفسرون الأقدمون يتحكمون في ماذا نلبس اليوم؟ وماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ وكيف نتكلم؟ وكيف نعبد؟ وكيف نسلك؟ وإذا حاول إنسان ما أن يحقق إنسانيته في علاقته مع الله، وينفذ إلى جوهر الوصية لا شكلها، أصبح عبداً ضالاً خارجاً عن الدين، فتفسير الأقدمين، هو التفسير الإلهي للوصية.
لكن السؤال هو: هل هذا هو الوجه الحقيقي للمسيح؟! لقد قابل السيد المسيح مواقف كثيرة في حياته كان عليه أن يبدي فيها رأيه عن العلاقة بين الإنسان والله والوصية. ففي مرة رأى مريضاً وأحسَّ أنَّ لديه رغبة في إبرائه، وبالطبع له القدرة على شفائه. لكن المشكلة تمثلت في أنّ اليوم كان سبتاً. فإذا شفاه كان كاسراً للوصية عاصياً لله، وإذا تركه أحس بالألم في داخله. وهنا تأمل المسيح في الوصية لا كهدف في ذاتها لكن كوسيلة وتأمل في الله وهو يضع الوصية.. هل وضعها لخير الإنسان أم لضرورة ما، وفكر أيهما أهم في نظر الله، الإنسان أم حرفية الوصية. وفي لحظة توصَّل إلى قرار: هو أنّ السبت جُعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت، وأنه يحل فعل الخير في السبت. فتقدم وشفى الإنسان رغم انتقادات الفريسيين ﴿إحدى الجماعات الدينية المتشددة﴾، ومحاولة محاكمته من رجال الدين والتشاور عليه لكي يهلكوه.
إنَّ المشكلة التي نعيشها اليوم هي أننا نتخيَّل إلهاً صغيراً بحجم تفكيرنا، نشكله بحسب تشكيلنا النفسي والاجتماعي، فنصنع إلهاً لنا ونعبده. وهذا لا يختلف كثيراً عن عبادة الأصنام في القديم. فنحن نصنع إلهاً من تخيلنا ثم نعبده، وندين الناس من خلاله. هذا الأسلوب جعل الناس يتشككون في كل شيء من حولهم، أصبح لا حول لهم ولا قوة، إذ هم يحسون أنهم في كل لحظة يكسرون وصية، وكلما كسروا وصية أصبح الإحساس بالذنب سيداً عليهم وترسبت عقد الذنب في دواخلهم، وأثر ذلك على انطلاقهم الروحي والفكري وعلى علاقتهم بالله. فقد أصبح الناس يحسون أنهم يحملون ذنوباً جسيمة وهم يأتون إلى الله، مع أنهم - حقيقة - لا يحملون كل هذا الكمّ من الذنب. رغم أنهم يعيشون كالعبيد، لأنهم اختاروا لأنفسهم عقائد وديانات تستعبدهم من خلال فرائض ووصايا.
وهكذا وُجد على الأغلب ثلاثة أنواع من البشر: الأول رفض الله رفضاً نهائياً، وصرح بعدم وجوده وأصبح الانسان مرجع حياته، والثاني ألقى بنفسه تحت نير الوصايا والفرائض وأصبح غير خلاَّق، فعاش حياة التخلُّف والطفولة الإيمانية. والثالث يعيش الصراع بين القيم الدينية والواقع، ولا يعرف كيف يعيش الوصية بذهن مستنير كابن لله.
لكن دعوة المسيح هي نوعية أخرى من الحياة تختلف عن هذه النوعيات الثلاث. إنها تدعو الإنسان إلى حياة يكون فيها حر الإرادة رافع الرأس، مع إله يحترم إنسانيته ويعامله كابن، ويفضله على حرفية الوصية. يثق فيه ثقة كاملة - يوضح له فقط الإتجاه العام الذي يريده أن يسلك فيه، والهدف الذي يراد الوصول إليه، ثم يترك له كيفية وسبل التطبيق: "الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها" ﴿يوحنا 14: 12﴾.</H2> | |
|
 †††
††† †††
†††

 †††
††† †††
†††

 †††
††† †††
†††
